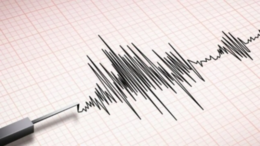أميركا أوهن من خصومها
السياسية || محمد محسن الجوهري*
تؤكد الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر، وما سبقها من شواهد تاريخية متراكمة، أن الولايات المتحدة، شأنها شأن قوى غربية أخرى، استفادت طويلًا من هالة إعلامية ضخمة صاغت صورتها كقوة كبرى لا تُقهر في وعي الرأي العام العالمي، بينما يكشف الواقع العملي عن فجوة واضحة بين هذه الصورة المروَّجة وبين القدرة الفعلية على فرض الإرادة في الميدان. فالقوة كما تُعرض في الخطاب الإعلامي والسياسي لا تعكس بالضرورة حجم النفوذ الحقيقي أو القدرة على الحسم.
لقد ساهم التفوق الإعلامي، وهيمنة السردية الغربية على وسائل الاتصال الدولية، في تضخيم صورة القوة الأمريكية، وتحويلها إلى رمز للهيمنة المطلقة، حتى بات مجرد ذكرها كافيًا لردع الخصوم أو إخضاع الحلفاء. غير أن التجارب المتكررة، من حروب طويلة بلا حسم، إلى أزمات إقليمية عجزت واشنطن عن إدارتها أو احتوائها، أظهرت أن هذه الهيبة تقوم في جانب كبير منها على الانطباع لا على الواقع.
وفي سياق البحر الأحمر، تبدو هذه الحقيقة أكثر وضوحًا، إذ اصطدمت القوة العسكرية المتقدمة بحسابات سياسية وأمنية معقدة حدّت من قدرتها على فرض السيطرة أو تحقيق أهداف واضحة. فالتكنولوجيا المتفوقة، وحشد القطع العسكرية، لم يترجما إلى نتائج حاسمة، ما كشف حدود القوة حين تواجه فاعلين أقل كلفة، وأكثر استعدادًا لتحمّل تبعات الصراع، وأقرب إلى مسرح العمليات.
وبالنسبة لواشنطن فإن النصر مقون بالحسم العسكري، وفي حال فشلت في ذلك رغم التفوق التقني الكبير بينها وبين اليمنيين، فكيف لو توحد العرب أجمعين في مواجهتها، عندئذٍ ستُهزم وتنتقل هيمنها على البحار والمحيطات إلى العرب أنفسهم، ولكن العرب أضاعوا تلك الفرصة يوم سمحوا لثقافة التفريق بغزوهم ورضوا بأن يتحولوا إلى كيانات صغيرة تتناحر فيما بينها باسم الوطنية التي رسختها عقيدة "سايكس بيكو".
فالعرب، بما يملكونه من موقع جغرافي استثنائي، وعمق بشري، وثروات نفطية، وسيطرة طبيعية على أهم الممرات البحرية في العالم، كانوا قادرين على قلب معادلات الهيمنة الدولية، على مستوى البحر الأحمر والخليج، وحتى على امتداد البحار والمحيطات التي تمر عبرها شرايين التجارة العالمية. غير أن هذه الإمكانات الهائلة جرى تفتيتها قبل أن تتحول إلى قوة، حين سُمِح لثقافة التفريق أن تحل محل الوعي الجمعي، وللهويات الضيقة أن تتغلب على المعنى الأشمل للأمة.
لقد تحوّل التقسيم من إجراء سياسي مؤقت إلى عقيدة راسخة، تُمارَس باسم الوطنية والسيادة، بينما تُستخدم عمليًا لإدامة الضعف ومنع أي مشروع قوة حقيقي. وهكذا، بدل أن تكون الجغرافيا مصدر تفوق، صارت ساحة تناحر، وفي ظل هذا الواقع، لم تُهزم الهيمنة الخارجية بقوة الخصم، بل بانكسار الداخل، حيث ضاعت اللحظة التاريخية التي كان يمكن فيها تحويل التحدي إلى بداية استعادة الدور، في مواجهة واشنطن، وكذلك في إعادة صياغة موقع العرب في ميزان العالم.
ولأن العرب قبل الإسلام كانوا عبارة عن قبائل جاهلية متحاربة فيما بينها، فإنهم اليوم يعيشون نفس المرحلة ولكن استبدلت الدولة بالقبيلة، ولذلك لن يصلح أمر آخرها إلا بما صلح به أمر أولها، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بنى النموذج الأقوى في تاريخ العرب، وجعل منهم نموذجاً يحكم العالم بمنطق الرحمة قبل القوة، وحتى يكونوا كذلك عليهم اتباع المنهج القرآني الذي هو أوسع من الحياة والعصر، وبموجب توجيهاته يستطيع العرب أن يستعيدوا مصادر قوتهم، فالقرآن يوجب على المسلمين الاعتصام والوحدة تحت راية العترة النبوية، الأشداء على الكفار الرحماء بينهم، وهو المشروع الديني الوحيد القادر على رفع العرب ومنحهم كل أسباب القوة، وفي ذلك تنفيذ الوصية النبوية في خطبة الوداع، "كتاب الله وعترتي"، فهنا المنهج والقيادة ولا بد منهما معاً لتكون هناك أمة قوية كما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله.
* المقال يعبر عن رأي الكاتب