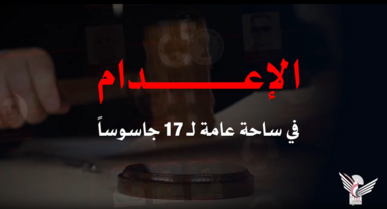الصراع بين النوويتين: كشمير بين مقاومة الداخل وردع النووي
السياسية || كيان الأسدي*
لم تعد كشمير مجرّد قضية حدودية عالقة بين دولتين نوويتين، بل تحوّلت إلى عقدة جيوسياسية ودينية متجذرة، تُجسد صراعًا حضاريًا يتجاوز الجغرافيا ليطال الهوية، والانتماء، والتوازن الإقليمي. ففي قلب هذه البقعة الجبلية المتنازع عليها منذ العام 1947، تختزن جذورٌ تاريخية عميقة لصراع مفتوح بين مشروعين متناقضين: مشروع هندوسي قومي يسعى للهيمنة والضمّ بالقوة، ومجتمع مسلم يرفض الخضوع ويُجدد مقاومته مع كل جولة قمع أو محاولة طمس.
كشمير ليست مجرد إقليم، بل شاهد حي على ما يمكن أن تفعله الأنظمة المدعومة بالاستعمار القديم والجديد حين تُطلق يدها في قمع الشعوب، وتوظّف التواطؤ الدولي لتبرير الاحتلال والاستيطان والتغيير الديموغرافي.
أولًا: الجذور التاريخية للصراع
تعود جذور النزاع الكشميري إلى لحظة تفكك الهند البريطانية في عام 1947، حين أُتيح للدول الأميرية آنذاك خيار الانضمام إلى الهند أو باكستان، بحسب الانتماء الديني والجغرافي. غير أن مهراجا كشمير، الذي كان هندوسيًا يحكم أغلبية مسلمة، اختار ضم الإقليم إلى الهند خلافًا لإرادة السكان، مما أشعل أولى الحروب بين الهند وباكستان وأدى إلى تقسيم كشمير فعليًا.
ورغم مرور أكثر من سبعة عقود، لم تتمكن الأمم المتحدة، ولا القوى الدولية، من فرض استفتاء لتقرير مصير الشعب الكشميري، بل تم تكريس واقع التقسيم والاحتلال، مع دعم غربي واضح للهند، خاصة من بريطانيا، التي كانت راعية للمشروع الاستعماري في شبه القارة، ثم من الولايات المتحدة التي تنظر إلى الهند اليوم بوصفها حليفًا استراتيجيًا في مواجهة الصين.
ثانيًا: الأبعاد الدينية والديموغرافية
يشكّل البعد الديني أحد أكثر أبعاد النزاع حساسية وخطورة، فالهند، منذ صعود اليمين الهندوسي المتمثل بحزب “بهاراتيا جاناتا”، تنتهج سياسة صريحة في “هندسة الهوية” في كشمير، عبر طمس الطابع الإسلامي وفتح الباب أمام استيطان هندوسي ممنهج، يترافق مع قمع ديني، وحظر للمؤسسات الدينية، واعتقالات تطال علماء الدين والناشطين.
وتجلت هذه السياسات بأوضح صورها في قرار نيودلهي عام 2019 إلغاء المادة 370 من الدستور، التي كانت تمنح الإقليم وضعًا خاصًا، مما فتح الباب أمام امتلاك الهنود للأراضي الكشميرية لأول مرة، وأطلق العنان لمشاريع استيطانية تهدف لتغيير البنية السكانية واستبدال الأكثرية المسلمة بأقليات هندوسية.
هذا التغيير الديموغرافي ليس مجرد إجراء داخلي، بل هو شكل من أشكال الاحتلال الصامت، يتقاطع مع التجربة الصهيونية في فلسطين، ويهدف إلى تحويل كشمير من إقليم مسلم يُطالب بتقرير مصيره، إلى إقليم خاضع ومُنصهر ضمن الهوية الهندوسية القومية.
ثالثًا: الهيمنة العسكرية والقمع المنهجي
الهند تنشر في كشمير أكثر من 700 ألف جندي، في واحدة من أعلى كثافات الانتشار العسكري في العالم بالنسبة لعدد السكان. وترافق هذا الوجود العسكري بحالة طوارئ دائمة، وفرض قوانين استثنائية تتيح للجيش الهندي قتل واعتقال دون مساءلة.
تُسجل منظمات حقوقية عالمية، بما فيها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، مئات الانتهاكات السنوية، تتراوح بين الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والإعدامات الميدانية، فضلًا عن سياسة الحصار الإعلامي وقطع الإنترنت المتكرر، وكل ذلك يُمارس تحت غطاء قانوني محلي وعجز أممي مريب.
رابعًا: حرب المياه… وجه آخر للصراع
في خضم الصراع المفتوح بين الهند وباكستان حول كشمير، يبرز ملف المياه كجبهة صراع غير مباشرة لا تقل خطورة عن الجبهات العسكرية. فمن خلال سيطرتها الجغرافية على منابع نهر السند وروافده الأساسية مثل نهر جيلوم وتشيناب، تمتلك الهند موقعًا استراتيجيًا يمكّنها من التحكم في شريان الحياة الزراعية والاقتصادية لباكستان.
ورغم توقيع “اتفاقية مياه السند” عام 1960 برعاية البنك الدولي، والتي نصّت على تقاسم الأنهار الستة بين البلدين، إلا أن الهند استغلت الثغرات القانونية في الاتفاق لتشييد عدد من السدود الضخمة على الروافد الغربية التي تُعتبر حيوية لباكستان. هذه المشاريع لم تكن مجرد بنى تحتية بل أدوات ضغط سياسي واقتصادي، تُستخدم كورقة مساومة أو تهديد في اللحظات الحرجة من النزاع.
وقد حذّرت باكستان مرارًا من أن العبث بالتدفق الطبيعي للمياه يمكن أن يُعتبر “إعلان حرب”، خاصة في ظل اعتمادها الكبير على الزراعة، وغياب البدائل الاستراتيجية لمصادر المياه. بهذا، تتحول المياه إلى سلاح صامت في صراع كشمير، يُلوّح به في الخلفية كلما تصاعد التوتر بين البلدين.
خامسًا: التحالفات الدولية… الكيان الصهيوني في كشمير
ما يلفت الانتباه في صراع كشمير هو تقاطع التحالفات التي تُعيد إنتاج مشهد الاحتلال بأوجه متعددة.
فالهند، رغم كونها دولة تدّعي الانفتاح والديمقراطية، تُعد اليوم من أوثق حلفاء الكيان الصهيوني، وقد تطوّرت العلاقة بين الجانبين لتشمل المجالات العسكرية، الأمنية، التكنولوجية، وحتى العقائدية.
تتشارك الهند والكيان الصهيوني في العقيدة الاستيطانية: الاحتلال، التوسع، وتغيير الهوية الدينية والديموغرافية للأرض. وفي الوقت الذي تُزوَّد فيه تل أبيب بأنظمة مراقبة إسرائيلية الصنع لقمع الفلسطينيين، تُستخدم نفس التكنولوجيا في كشمير لتعقّب النشطاء، وإحكام القبضة على الشعب المسلم هناك.
كما أن الهند لعبت دورًا لوجستيًا خفيًا في دعم الكيان الصهيوني خلال العدوانات الأخيرة على غزة، عبر توفير قطع غيار للطائرات، وفتح خطوط إمداد تحت غطاء التعاون الصناعي. هذا التحالف يُبرز عمق التشابه بين النموذجين، ويكشف كيف تتحول كشمير إلى فلسطين أخرى، تُدار أدوات قمعها بنفس اليد التي تنكّل بالشعب الفلسطيني.
في المقابل، لم ترتقِ المواقف الإسلامية الرسمية إلى مستوى التحدي، واكتفى معظمها بإصدار بيانات التضامن دون تبني مواقف سياسية فاعلة. بل إن بعض الأنظمة الخليجية عملت، بشكل غير مباشر، على إضعاف المقاومة الكشميرية عبر محاولات احتوائها، أو تسويق رواية “التنمية مقابل الاستقرار”، وهي نفس المعادلة التي يُراد فرضها على شعوب المنطقة برمتها.
سادسًا: المقاومة الكشميرية… بين نيران الداخل وتخاذل الخارج
ورغم كل القمع الهندي، والإغلاق الأمني، والرقابة الإلكترونية المشددة، لم تخمد جذوة المقاومة الكشميرية. لم تُكسر إرادة شعب يُقاتل لأجل هويته وكرامته، في ظل احتلال يجرّده من حقه في التنقل، التعليم، والعيش الكريم. المقاومة في كشمير لم تعد محصورة في التشكيلات المسلحة، بل تحوّلت إلى حالة مجتمعية، تتجلى في الإضرابات، التظاهرات، العصيان المدني، ومقاطعة مؤسسات الاحتلال.
الهند تعي خطورة هذه المقاومة “الناعمة” بقدر ما تخشى العمل المسلح، ولهذا تبذل جهدًا غير مسبوق في محاولات الهندسة الثقافية، وتجنيد الإعلام والتقنيات الحديثة لغسل العقول وتفكيك البنية الاجتماعية الإسلامية في الإقليم. لكنها تصطدم دومًا بحقيقة أن الشعب الكشميري لا يرى في الهند سوى قوة استعمارية مفروضة بقوة السلاح.
أما الموقف الدولي، فظل مرتهنًا للازدواجية الغربية. فمن جهة تُنتج تقارير حقوقية تفضح الانتهاكات في كشمير، ومن جهة أخرى تُمنح الهند صفقات أسلحة وتكنولوجيا مراقبة متطورة، في ظل اعتبارها شريكًا استراتيجيًا في مواجهة الصين، ومحورًا لتوازن القوى في آسيا.
كشمير بين مقاومة الداخل وردع النووي
كشمير اليوم ليست مجرد نزاع حدودي، بل مفصلٌ من مفاصل إعادة تشكيل جنوب آسيا. إنها قضية هوية وثقافة وحق في تقرير المصير. وإزاء تعقيد المشهد، لا تزال كشمير تقف ما بين مقاومة الداخل المتواصلة، وردعٍ نووي تملكه باكستان، التي وإن بقي خطابها سياسيًا وداعمًا في العلن، إلا أن رهانها الأساسي ظلّ على قوة الردع في وجه الهيمنة الهندية.
الصراع إذًا يحمل طابعًا مركبًا: بين مقاومة شعبية غير قابلة للكسر، وتحالفات دولية تفرض وقائع قسرية على الأرض، في ظل صمت عربي وإسلامي رسمي، لا يختلف كثيرًا عن الصمت الذي خيّم على قضية فلسطين.
الهند تسعى لتكريس مشروع “الهندوسية السياسية” في كشمير، تمامًا كما تسعى إسرائيل لتكريس يهودية الدولة في فلسطين. والمقاومة في كلا الحالتين تُعبّر عن وعي شعبي عميق بأن الصراع ليس فقط على الأرض، بل على الوجود والهوية والحق التاريخي.
وفي ظل هذا التوازن المعقّد، فإن أي تصعيد غير محسوب قد يقود إلى مواجهة كارثية، خاصة مع امتلاك الطرفين للسلاح النووي، ما يجعل من كشمير واحدة من أخطر بؤر التوتر العالمي، التي لم تُنصف بعد، لا بالقرارات الدولية، ولا بتوازنات الردع، ولا حتى بضمير العالم.
فهل سيكون وقف إطلاق النار خطوةً على طريق التهدئة، أم مجرّد هدنة هشّة تؤجّل الكارثة ولا تمنعها؟ وهل يكفي لدرء شبح الحرب، أم أن الجمر لا يزال متّقداً تحت الرماد؟
* كاتب وباحث بالشأن العراقي والإقليمي
*المقال يعبر عن رأي الكاتب